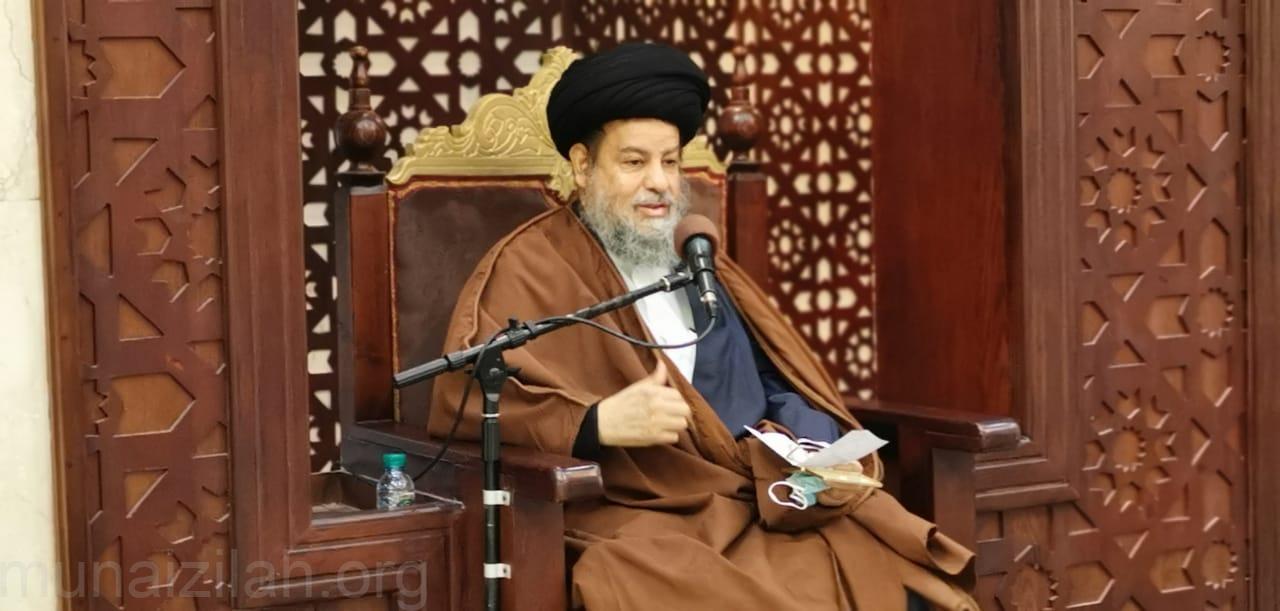قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) آية 164 سورة آل عمران.
توطئة..
إننا نعيش ذكريات هي أليمة لكنها باعثة على المسرة والفرح والأمل، فكيف يعيش الإنسان الألم وفي الوقت ذاته يعيش الذكرى الباعثة على المسرة والفرح؟!
ففي مثل هذه الأيام تطالعنا ذكرى رحيل العالم الجليل والمرجع الكبير السيد أحمد الخوانساري الذي يعتبر أحد المقدسين المسلمة قداستهم عند فقهاء عصره، فهو مرجع ديني محترم عند مراجع عصره، وكتابه (المدارك في شرح المختصر النافع) كتاب معروف، كما أننا نعيش ذكرى رحيل الشيخ الجليل سماحة الشيخ حسن السعيد رحمة الله عليه.
هذان ذكريان مؤلمتانِ فمن أين تأتي جنبة الفرح؟!
بالنسبة لهذين الجليلين فإن الفرح والسعادة ـ حقيقةً ـ تأتي من كونهما لم يرحلا من هذه الدنيا إلا وقد تركا لهما آثارًا، هذه الآثار وصلت إلينا عبر المؤمنين الذين تربوا على أيديهما وعبر تلامذتهما وعبر تراثهما وكتبهما، الفرح هنا ـ حقيقةً ـ فمثل هؤلاء لم يموتوا فينسوا وتنسى شمائلهم، هؤلاء باقون فينا؛ لأنهم تركوا تراثًا وتركوا طلابًا، وتركوا مؤمنين متأثرين بهم، من هنا جاءت الفرحة في ذكرى رحيل هذين العالمين الجليلين.
ذكرى رحيل المرجع الكبير السيد أحمد الخوانساري (ق.س):
إن الأمر الذي دعا إلى أن يخلد المقدس الخوانساري رضوان الله عليه، ويُخلد الشيخ حسن السعيد رحمة الله عليه هو الارتباط بالدين والقيم، فالدين والقيم هما مسألتان يهتم بهما الإنسان منذ وجد على هذه الأرض، وواقعا ينبغي للإنسان أن يؤكد على هذين الجانبين فإن أي إنسان يتصدى لعمل لابد أن يكون مرتبطا بالدين ومرتبطا بالقيم هذا هو المراد حينئذ.
شيخانِ فاضلانِ من هذا البلد أفتخر بهما..
وبالنسبة لي شخصيًا ولله الحمد والمنّة فإنني أعرف كثيرًا من طلاب هذه المنطقة وبالخصوص سماحة الشيخ كاظم الحريب فقد عشت وإياه قُرابة إحدى وثلاثين سنة أو اثنتين وثلاثين سنة ، كذلك سماحة الشيخ حبيب الأحمد فهذان ـ واقعا ـ إذا ما جئتُ لأمتدحهما وأثني عليهما فإنني أكاد أمتدح نفسي وكأنني أثني على نفسي؛ لأن هذين الشيخين الجليلين من أبنائي وحقيقة هما شخصانِ متدينانِ ومن أصحاب المبدأ والقيم ؛ لذا ينبغي الالتزام بأقوالهما والامتثال بأفعالهما والاسترشاد بتوجيهاتهما ؛ لأن هذين وأمثالهما واقعا يربطونك بالله ويربطونك بالقيم والمبادئ.
لخدمة الأخلاق والقيم..
وعلى العموم وبشكل مختصر وحتى لا أطيل في هذا الجانب فإن الآية الكريمة التي افتتحنا بها حديثنا تتحدث عن مهام الأنبياء، فما هي مهام الأنبياء تلك وما هي المهمة التي أوكلها الله لهم؟
تقول هذه الآية الكريمة ( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً )، فذكرتْ الآية أن الله بعث رسولاً ولم تقل ملكًا من الملائكة وهذا الرسول هو شخص من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إذن من أهم وظائف الأنبياء وظيفة مهمة ألا وهي وظيفة التعليم؛ لذا نجد أن رسول الله (ص) قال: ( إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق )، إضافة إلى حقيقة مهمة وهي أن الدين كله جاء لخدمة الأخلاق وخدمة القيم، ولدينا ثمة قيم دينية وثمة قيم أخرى وهي قيم أخلاقية كما أن لدينا قيم تربوية هذه الثلاثة الأنواع من القيم يجب أن ينبعث الإنسان إليها بما يسمى بالوازع، إذن الإنسان أُعطي هذه القيم من خلال التربية .
الانضباط هو المنشأ..
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هنا هو أن هذه القيم بعثت الإنسان إلى ماذا؟
أجل! إن هذه القيم قد بعثه إلى الانضباط، والشيء بالشيء يذكر فعندنا مثل (حساوي) جميل ـ حقيقة ـ فماذا يقول هذا المثل الحساوي يا تُرى؟! يقول هذا المثل: ( اللِّي ما يِسُوقَه مَرْضَعَهْ سُوق العَصا ما ينفعَهْ )، إذن المسالة مرتبطة بحالة الانضباط التي يبعثك نحوها هذا الوازع، وإنما نسميه بالوازع ؛ لأن منشأه تربويّ أو دينيّ أو ما نعبر عنه قيميّ، إن الوازع وازع أخلاقيّ؛ لذا فبعض الروايات تتحدث كثيرًا عن هذه الصفات ، قال رسول الله (ص): ( أكثر ما يلج به أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق )، فقد ركز على التقوى وحسن الخلق.
ما المراد بالتقوى؟
لذلك الإسلام يؤكد كثيرًا على مسألة التقوى، فالتقوى مهمة جدًا، لذا فإننا وجدنا أن الرواية ولآية تصبّان في هذا المصب، وهنا يطيب لنا أن نذكر رواية جميلة ( أن الرسول الأعظم (ص) أتاه رجل بين يديه فقال له: يا رسول الله ما الدين؟ فقال: حسن الخلق، ثم أتاه من قبل يمينه، وكأنه يريد بهذا الفعل أن يقول لعل الرسول لم يسمعني؛ لذا جاء عن يمينه فقال له: ما الدين، فقال رسول الله حسن الخلق، ثم أتاه عن يساره فقال: ما الدين، قال له: حسن الخلق، ثم أتاه ـ وكما تقول الرواية ـ من خلفه: فقال له: ما الدين يا رسول الله، تقول الرواية فالتفت إليه فقال: أما تفقه، هو أن لا تغضب، إذن حسن الخلق هو ذاته حسن الخلق، وهي الصفة التي تدفعك لما يريده الله.
الآيات القرآنية تؤكد على هذا: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ).
فالتقوى ما المراد منها إذن؟!
التقوى وكما يُعرِّفها علماء الأخلاق أنها حالة روحية وقدرة داخلية نفسانية بها يستطيع الإنسان طاعة الله وترك معصيته.
إذن الهدف من التقوى أمران: الطاعة وترك المعصية، وهذا أهم شيء في الدين، طبعا سعة الأخلاق وغيرها كلها مركوب التقوى فالإنسان إذا أراد أن يكون متَّقيًا فعليه بالأخلاق، فالأخلاق شيء مهم جدًّا؛ لذلك الروايات والآيات حينما تتحدث عن التقوى فإنها تتحدث عنها من هذا الجانب.
وكفهرسة أقول:
إن التقوى مرتبطة بتزكية النفس، وتزكية النفس لها أمران مهمّان:
1 ـ علاقات اجتماعية:
فتزكية النفس ليس معناها البعد عن الناس؛ لأن الدين كله علاقات اجتماعية تبدأ من صلاة الجماعة، والإحساس بالمجتمع عبر الصوم، وتحسس آثار المجتمع عبر الحج، وعبر الزكاة وعبر الخمس، فكل العبادات كلها ذات جَنبة اجتماعية.
2 ـ بُعْدُ الإنسانيّ:
كما أنه لا بد حينئذ أن يكون في التزكية بُعْدًا إنسانيًّا بجانبيه:
الجانب الأول:
بُعْدُ الكمال الإنساني حيث ينبغي على الإنسان أن يسعى لأن يتكامل.
الجانب الثاني:
التكامل عبر حب الله عز وجل.
هذه أمور مهمة، علاقات اجتماعية يتكامل فيها الإنسان نفسيًّا وروحيَّا ليصبح الإنسان إنسانًا؛ لذلك بعض العلماء العرفانيين يقول: (من السهل أن يصبح الإنسان متديّنًا أو مؤمنًا لكن من الصّعب أن يصبح الإنسان إنسانا)، بحيث يكون المحرك له هو الإنسانية، ومن ضمن تحريك الإنسانية التقوى، فالله ـ عز وجل ـ يتحدث عن العبادة وهي المهمة جدًّا أن يصبح الإنسان إنسانا وعابدا في نفس الوقت، هذا شيء كبير؛ لذا فأمير المؤمنين يقول عندما تحدث عن حالة هو عليه السلام يشعر بها، فالقران يقول:
( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) ومن هذا المنطلق المتعلق بالحالة الأكثر تقدما في العبادة يقول أمير المؤمنين (ع): (إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك)،وهذا هو الكمال الإنساني؛ لذا الكامل إنسانيًّا يشعر بكل فرد من أفراد الأمة، ويحاول أن يكون ذا طابع اجتماعي، هذا الفرق بينه وبين غيره.
والخاتمة خطوة ونتيجة..
لذلك ـ واقعًا ـ هذه المسألة مهمة والتركيز عليها أهم ـ حينئذ ـ لذلك الإنسان في بُعْدِه الإنسانيّ يرجع إلى معرفة كرامته ومعرفة مكانته في هذا الخَلق، وإذا أراد أن يكمل أو أن يبدأ كماله الإنسانيّ فعليه أن يفرق بين أمرين: تصفية النفس التي تُسمى بالتخلية، وطريق الوصول، أما طريق الوصول فيتمثل في ذكر لسانيّ وذكر قلبيّ، وحضور وجوديّ، هذه المسائل يجب على كل مؤمن وكل إنسان أن يبدأ بها، فإنه إذا بدأ ـ حقيقة ـ سيصل إلى ما يصل إليه أحيانا كبار العلماء، وأتذكر كلمة للإمام رضوان الله عليه حينما كان يَستشهد بعض الشباب الصغار وهؤلاء الشهداء لم يكونوا من طلاب العلم، فكان الإمام الراحل يقول عن هؤلاء الشهداء أن هؤلاء وصلوا إلى معرفة الله ـ عز وجل ـ أكثر مما وصله كثير من كبار العلماء.
إذن فكثير منكم من الشباب من المؤمنين هم واقعًا واصلون، والدليل على ذلك مستوى إيمانهم وتدينهم، لكن يحتاجون فقط إلى الخطوة الثانية وهذه الخطوة هي مسألة الوعي والمعرفة تلك التي نسميها بالتزكية والتقوى.